اليوم 167 منذ إصابتي بكوفيد طويل الأمد.
لطالما مثّل لي الموت -كما ينبغي له- أزمة وجودية. أرى أن الموت يجب أن يمثّل لكل من يملك عقلًا بشريًا أزمة من نوع ما.
أذكر حين كنت في السابعة، أجلس في السرير الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أحدّق في جسد شقيقتي النائم بجواري، ويخبرني الصوت في رأسي: "لقد ماتت! إنها ميتة!"، فأبدأ في الهلع، وأتخيل أن جسدها ساكن، وأن صدرها لا يتحرك مع كل شهيق وزفير، ثم أبدأ في هزّها لتستيقظ. أردد: "إيمان، إيمان، اصحي".
ولأن شقيقتي عنيدة -وأيضًا عميقة النوم- فقد كانت تأبى الاستجابة لكل نداءاتي وتوسلاتي لها بأن تستيقظ، فأبدأ حينها في البكاء، وتصديق أنها قد ماتت لا محالة، وأبدأ في التفكير في معضلة إخبار أمي وأبي بخبر وفاتها في الصباح.
أعرف أن كثيرًا من الأطفال مروا بذات الموقف، الأطفال ميلودراميون كما تعرف.
ولكن، في الحقيقة، لم يتغير شيء للآن وأنا في الرابعة والعشرين. لا زال ذلك الهاجس يؤرقني، أعني، أرى أن كل كائن حي واعٍ بوجوده يجب أن يُقَضّ مضجعه كل ليلة بهذا الموضوع، إلا إذا كنت تُجيد تشتيت نفسك عن تلك الحقيقة، ربما بالتصديق في وجود أحد الآلهة، أو بممارسة اليوجا، أو بشرب الكحول بكميات غير معقولة. أيًا تكن إستراتيجية فَرّق-تسُد الخاصة بك، واصل القيام بها، أنت تقوم بعمل جيد.
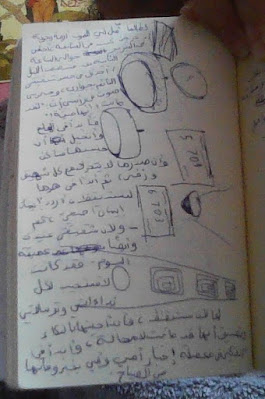
تعليقات
إرسال تعليق